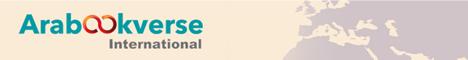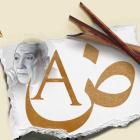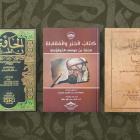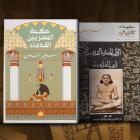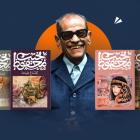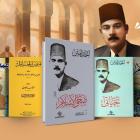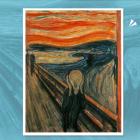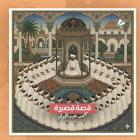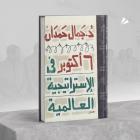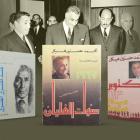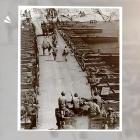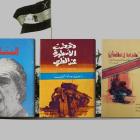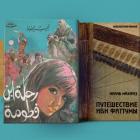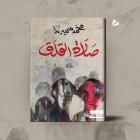معرفة
الدليل على ضرورة النبوة للإنسان عند فلاسفة الإسلام
ماذا قال ابن سينا لتلميذه حين طلب منه ادعاء النبوة؟ وما سر حاجة الإنسان للنبوة ليكمل إنسانيته ويبلغ غايته؟ ولماذا يعجز العقل عن بلوغ الغاية بمفرده؟
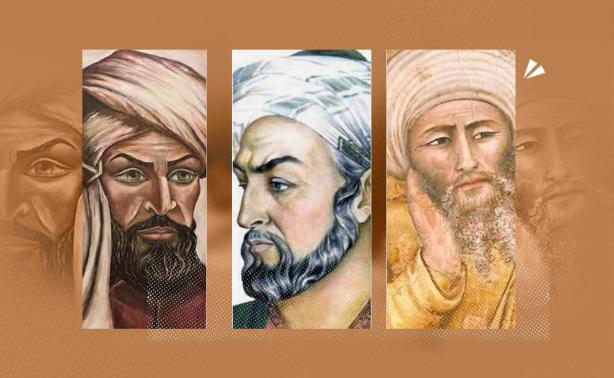 من اليمين: ابن رشد، ابن سينا، والخوارزمي
من اليمين: ابن رشد، ابن سينا، والخوارزمي
الله، معشوق البشرية الأزلي، الغاية التي نبحث عنها قيامًا وقعودًا وعلى جنوبنا. اختلفت الأديان والفلسفات حول صفاته، لكن الموصوف واحد. لا يستطيع أعتى الملاحدة إنكار الدور الذي يلعبه الدين في حياة أتباعه. ربما لا أكون مبالغًا إذا قلت إن الدين سمة أساسية وجوهرية من سمات المجتمعات الإنسانية، أياً كان الشكل الذي يتخذه هذا الدين. إن هذا الإدراك العميق لكون الدين مكوّنًا أساسيًا من مكونات النفس البشرية دفع بعض المفكرين إلى أن يصفوا النوع الإنساني بمصطلح homo religious أو «الإنسان المتدين»1. وهذا ليس إلا تلاعبًا بالاسم العلمي لنا نحن كبشر وهو homo sapiens أو «الإنسان العاقل».
هل لا نزال في حاجة للدين في عصرنا الحالي؟ يقول الفيلسوف التونسي الكبير د. فتحي المسكيني في لقاء معه:
«الدين إلى حد الآن يبرر نفسه بالموت، ليس له أي تبرير أخلاقي آخر. ما عدا ذلك، يمكن للدين أن نعوضه بأي سوسيولوجيا أو ثقافة أو أي نوع من الثرثرة الأخلاقية»2.
يقصد المسكيني أنه ليس للدين دور في عصرنا الحالي إلا إعطاء معنى للموت، أما فيما عدا ذلك فيمكننا أن نستعيض عنه بأي فلسفة أخرى. فهل ما قاله الدكتور المسكيني صحيح؟ هل باستطاعتنا أن نعرف كيف يعيش الإنسان حياة طيبة من دون الدين؟
من ناحية أخرى، نجد الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس والأنثروبولوجيا (علم الإنسان) الغربيين خطّوا بيراعهم ما يؤكد أهمية الدين في إعطاء المعنى للبشر في حياتهم قبل مماتهم، مثل سورين كيركيجارد، رودولف أوتو، كارل يونج، مرورًا بجوزيف كامبل، ومرسيا إلياد، وبول تيليش.
النبوة العامة والخاصة
تُعد ظاهرة النبوة ركنًا أساسيًا في الأديان التوحيدية (اليهودية، المسيحية، الإسلام)، وهذا بديهي؛ إذ كيف ستتواصل السماء مع الأرض إلا عبر نبي مرسل؟ لقد خطّ المتكلمون (علماء الكلام) والفلاسفة المسلمون بمداد فكرهم وعلمهم الكثير حول مبحث النبوة العامة.
إن الغاية من هذا المبحث هي الإجابة عن السؤال الآتي: هل يحتاج الإنسان إلى النبوة؟ وإذا كان يحتاجها، فهل من الضروري أن يبعث الله الأنبياء؟ إن هذا يختلف عن مبحث النبوة الخاصة الذي يحاول المشتغلون فيه إثبات نبوة خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام3.
سنحاول في هذا المقال الإجابة عن السؤال الذي يطرحه مبحث النبوة العامة: فهل نحن في حاجة إلى الأنبياء بالفعل؟ وإذا كنا في حاجة إليهم، فهل من الضروري أن يبعث الله أنبياءً لبني البشر؟
يرى أولو الألباب من حكماء (فلاسفة) الإسلام أنه بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه مطلق العلم والقدرة والخير، سنثبت أنه يوصل كل الموجودات إلى كمالها حسب استعدادها. ولكي يصل الإنسان إلى كماله، بعث الله أفرادًا منه يرشدون بني البشر إلى ما فيه كمالهم، وهم الأنبياء صلوات الله عليهم. سنحاول في بقية المقال أن نشرح ونبين للقارئ الكريم كيف وصل الحكماء إلى هذا الاستنتاج، ونفهم معًا معنى كمال الموجودات والكمال الإنساني.
نود أن ننوه إلى القارئ الكريم أن الاستدلال على النبوة العامة يأتي بعد الاستدلال على وجود الله وإثبات صفاته عز وجل؛ إذ كيف سنستدل على بعث الله للأنبياء دون أن نثبت وجوده سبحانه وتعالى؟ لكننا لسنا بصدد هذا المبحث في هذا المقال.
بعد أن أثبت الفلاسفة وجود الله وصفاته، وأنه مطلق العلم والقدرة، فسيكون من اليسير أن نستنبط أن هذا الخالق سيخلق كونًا في أعلى درجات الكمال والإتقان. والسؤال هو: كيف سيصل الكون بعناصره إلى هذا الكمال المنشود؟
لقد أثبت الفلاسفة أن الله تعالى تام الإفاضة، بمعنى أنه يجب أن يفيض بالكمال على كل الموجودات التي خلقها، أي يوصلها إلى كمالها4. وبما أن الإنسان من تلك الموجودات، فيجب أن يفيض الخالق عليه بالكمال اللائق به. لكن ما معنى كمال الموجودات أصلًا وكيف تصل إليه؟ وهل كمال الموجودات يختلف عن كمال الإنسان؟ ولماذا يجب أن يُفاض على الأشياء بكمالها؟
كمال الموجودات
الإلكترون يدور حول نواة الذرة، الإنسان يفكر، الذئب يفترس فريسته، الكواكب تدور حول شموسها، الشمس تحرق وقودها النووي، النبات يتغذى عبر عملية البناء الضوئي. لكل موجود من الموجودات مجموعة من الأفعال التي يقوم بها، والتي تحدد طبيعته وتميزه عن الموجودات الأخرى؛ فلا النبات يفكر ولا الإنسان يتغذى بالبناء الضوئي.
يسمي الفلاسفة هذه الأفعال بالكمالات. لماذا؟ لأنه إذا لم يستطع موجود ما أن يقوم بفعل ما هو من شأنه أن يفعله، ستنقص رتبته الوجودية. تخيّل أن عينك صارت عاجزة عن الرؤية (كمال العين في قدرتها على الإبصار)، سيكون هذا نقصًا قد اعتراها. إذا توقفت الشمس عن إحراق وقودها النووي ستموت، وإذا عجز إنسان عن التفكير فهذا يعني أنه يعاني من تأخر عقلي.
لكل موجود مجموعة من الكمالات التي تحدد طبيعته. لكن هل يستطيع شيء ما أن يكون أكثر كمالًا؟ بالتأكيد؛ فالبذرة تنمو لتصير شجرة، والشجرة أكمل من البذرة لأن لديها القدرة على القيام بأفعال لا تستطيع البذرة في رتبتها الوجودية أن تقوم بها. كذلك الطفل؛ فالطفل سيكبر ليكون أكثر كمالًا، ويكون شابًا يافعًا، ثم رجلًا حكيمًا له كمالات أكثر من الطفل.
نفهم من هذا أن الطفل والبذرة ناقصان من الناحية الوجودية، ولكن مع ما يُعرف بعملية الاستكمال بإمكانهما أن يصيرا موجودات أكثر كمالًا. لكل شيء كماله الأخير الذي لا يستطيع أن يصل إلى رتبة وجودية أعلى منه.
فالكمال الأخير لشجرة التفاح أن تكون شجرة مثمرة، ولا تستطيع مثلًا أن تصل إلى كمال أعلى فتصبح شجرة مفكرة. والكمال الأخير للنجم أن يكون نجمًا قادرًا على حرق وقوده النووي وجذب الكواكب حوله، ولا يستطيع النجم أن يكون كائنًا حيًا مثلًا. والكمال الأخير للشمبانزي أن يكبر ويكون قويًا، وقادرًا على التكاثر، وزعيمًا لمجموعة من القرود، لكنه لن يقدر على أن يفهم أسرار الكون.
فما هي العملية التي يترقى خلالها الشيء في سلم الوجود ليصبح أكمل حتى يصل إلى كماله الأخير؟
من القوة إلى الفعل
لنفهم معنى كمال الموجودات بصورة أكبر، فلنُرجِع أبصارنا وتليسكوباتنا كرتين في الموجودات، سنجد أن جميع الموجودات التي نعرفها في حالة تغير مستمرة؛ تولد النجوم وتموت، الأرحام تدفع والقبور تبلع، البذور تصبح أشجارًا وهكذا. حركة مستمرة لا تتوقف. مخلوقات تغادر مسرح الوجود وأخرى تدلف إليه.
يشير بزوغ موجودات جديدة في الكون بعد أن لم تكن ـ كميلاد الأطفال أو صغار الحيوانات أو تكوّن العناصر الجديدة في بطون النجوم ـ إلى أن هذه الموجودات كانت كامنة في موجودات أخرى موجودة بالفعل. فالشجرة مثلًا كامنة في بذرتها، والنار كامنة في الفحم.
رأى الحكماء أن تلك الموجودات الكامنة بصورة ما موجودة بالقوة، والموجودات الأخرى موجودة بالفعل. جميع الموجودات في كوننا هذا إما بالقوة وإما بالفعل. لهذا يقول الحكماء إن من أقسام الوجود «القوة» و«الفعل»5.
يقول أحد كبار حكماء الإسلام، والملقب عند البعض بالمعلم الثالث، وهو محمد باقر الداماد:
«أمّا تعرفت أن شيئًا من الأشياء لا يكون مخرج ذاته من القوة إلى الفعل؟ ولو كانت الذات بنفس جوهرها مستوجبة الخروج إلى الفعل، لما كانت بالقوة أصلًا»6.
يقصد السيد الداماد أنه لا يمكن لشيء بالقوة أن يُخرج نفسه بنفسه من القوة إلى الفعل، بل يحتاج إلى شيء موجود بالفعل يُحدث هذه الحركة أو هذا التغيير.
على سبيل المثال: إذا لم تكن هناك نار أو حرارة بالفعل، لن تخرج النار من تلقاء نفسها داخل قطعة الفحم من القوة إلى الفعل. وإذا جئنا ببذرة ولم نسقها بالماء، فلن تنبت البذرة شجرتها من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون هناك ماء بالفعل حتى ترتوي البذرة وتنبت.
نود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن تكامل الشيء حتى يصل إلى كماله الأخير بعد عملية من التغير التدريجي ـ كما ذكرنا سابقًا ـ إنما يتم عبر خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيًا، كخروج الشجرة من بذرتها تدريجيًا لتصبح شجرة مثمرة بالفعل.
الكمال الإنساني
جاء الآن دور السؤال الأهم وهو: ما أقصى غاية أو الكمال الأخير للإنسان؟ يتمثل كمال الإنسان وسعادته في قيامه بالأعمال الصالحة واعتقاده الاعتقادات الحقة الراسخة، فلقد ثبت في فلسفة الأخلاق لدى حكماء الإسلام أن كمال النوع الإنساني وسعادته في التمتع بالأخلاق الفاضلة ومعرفة الحق جل في علاه.
كيف أثبتوا ذلك؟ إن الإنسان حيوان ناطق، فهو يمتلك ما يُعرف بالنفس الناطقة الإنسانية، وهي العقل الذي يميزنا عن بقية خلق الله، وتنقسم قوى النفس الناطقة إلى قوة عاملة وقوة عالمة7. القوة العاملة هي القوة العملية التي تحرك الإنسان للقيام بأفعاله، والعالمة هي القوة النظرية التي يدرك بها الواقع حوله على حقيقته.
يقول الإمام فخر الدين الرازي:
«كمال حاله (أي الإنسان) محصور في أمرين: أحدهما: أن تصير قوته النظرية كاملة بحيث تتجلى فيها صور الأشياء وحقائقها تجليًا كاملًا تامًا مبرأً عن الخطأ والزلل. والثاني: أن تصير قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة يقدر بها على الإتيان بالأعمال الصالحة»8.
إذا سلمنا بما توصل إليه الحكماء بخصوص كمال الإنسان أو أكمل صورة يمكن أن يصل إليها الإنسان، سنلاحظ الآتي: إن كل الموجودات سواءً كانت حية أو غير حية يكون كمالها مودَعًا في صميم وجودها؛ فالنحلة تعرف كيف تصل إلى كمالها بقوانين علم الأحياء وغرائزها المودعة فيها، وكذلك الجسيمات تحت الذرية؛ فالإلكترون يعرف بدقة كيف ينبغي أن يدور حول البروتون... كما يعرف البروتون وبقية الأجزاء الأخرى في الذرة وظائفها على نحو تام، وهي تتحرك في خط التكامل حركة جبرية9.
ولكن هل كمال الإنسان المتمثل في الأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة الراسخة مودَعٌ في صميم وجوده بحيث إنه سيصل إليه بالآليات الطبيعية دون مساعدة من أحد؟ بالطبع لا.
من يخرج الفضائل من القوة إلى الفعل
يمتلك الإنسان نفسًا حيوانية يشترك فيها مع بقية الحيوانات، كما يمتلك النفس الناطقة التي تميزه. للنفس الحيوانية ما يُعرف بالقوة الشهوية، وهي القوة التي تعين الحيوان على التغذي والتكاثر، والقوة الغضبية، وهي التي تدفع عنه الشر والأذى. إن هاتين القوتين تخرجان من القوة إلى الفعل حالما يتفاعل أي حيوان مع البيئة المحيطة، لكن ماذا عن القوة الناطقة؟
إذا تركنا طفلًا في الغابة وقامت على تربيته حيوانات أخرى غير الإنسان (هذا من باب التمثيل ليس إلا)، ربما يتعلم بعد فترة المشي والاصطياد والدفاع عن نفسه، أي ربما يستطيع الوصول لكماله الجسماني، ربما! لكن هل سيستطيع الوصول إلى كماله النفساني المتمثل في أن يكون إنسانًا فاضلًا، وتخرج هذه القوة الناطقة من القوة إلى الفعل، إلا إذا قام بتربيته أحد الفضلاء من بني الإنسان؟ بالطبع لا.
إن خروج القوة الناطقة من القوة إلى الفعل شديد الصعوبة، لأن القوتين الشهوية والغضبية كثيرًا ما تطغيان عليها، والبيئة الطبيعية المحيطة ليست كافية لإخراجها من القوة إلى الفعل. يقول المرجع الشيعي الراحل السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله:
«والإحساسات التي هي بالفعل في الإنسان في بادي حاله هي إحساسات القوى الشهوية والغضبية، وأما القوة الناطقة القدسية فهي بالقوة... فهذه التي بالفعل لا تدع الإنسان يخرج من القوة إلى الفعل كما هو مشهود من حال الإنسان، فكل قوم أو فرد فقد التربية الصالحة عاد عما قليل إلى التوحش والبربرية مع وجود العقل فيهم وحكم الفطرة عليهم»10.
إذن، للوصول إلى كمالنا نحتاج إلى من تكون هذه القوة الناطقة فيه بالفعل والفضائل كذلك، لتخرج الفضائل فينا من القوة إلى الفعل. فمن هؤلاء الذين يخرجون الفضائل من داخل الإنسان من القوة إلى الفعل؟ إنهم الأنبياء.
هل العقل كافٍ؟
ربما يلوح سؤال في أذهان القراء، وهو: لماذا من الضروري أن يكون هؤلاء الذين يُخرجون فضائل الناس من القوة إلى الفعل أنبياءً يوحى إليهم؟ لماذا لا يكونون فلاسفة كأرسطو أو حكماء مصر القديمة والهند والصين؟ بمعنى آخر: لماذا ليس العقل كافيًا؟
إن هذا يرجع إلى خلقة البشر أنفسهم؛ فهل يفهم معظم البشر البراهين الفلسفية؟ هل تدفع هذه البراهين أغلبنا إلى السير على نهج الكمال؟ كلا. كيف إذن سيصل معظم البشر إلى كمالهم؟ يقول الفيلسوف المسلم الشهير أبو الوليد بن رشد في كتابه الماتع «فصل المقال»:
«وكان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين ولا الأقاويل الجدلية، فضلًا عن البرهانية... وكان الشرع إنما هو مقصوده تعليم الجميع»11.
كيف سيخاطب الشرع إذن الناس ليعلمهم؟ يقول المعلم الثالث السيد الداماد:
«إن دأب الحكماء الأقدمين وطريقة العقلاء الأولين هو تبيين الحقائق بلسان الرمز، وتصوير البرهانيات بصورة الخطابيات، وتغطية المعقولات بلباس المحسوسات... ومن المعلوم أن أكثر الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق، وإلى الخطابة أشوق منهم إلى البرهان»12.
نفهم من كلام ابن رشد والداماد أن الأغلبية الساحقة من البشر، حتى الحكماء منهم، لا تحركهم البراهين العقلية، بل تحركهم العاطفة والأشواق. يوضح كلام حكماء الإسلام أن مخاطبة الوجدان والقلب والعقل معًا أنجع من مخاطبة العقل وحده في نفوس بني آدم.
بين ابن سينا وبهمنيار
من القصص التي توضح الفارق بين تأثير الفلاسفة على العقول وتأثير أنبياء الله على عقول وقلوب أتباعهم تلك التي جرت بين ابن سينا وتلميذه بهمنيار. ففي أحد الأيام، اقترح بهمنيار قبل إسلامه على أستاذه الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا أن يدّعي النبوة! وذلك لما لديه من علم جم ومكانة سامقة. فلم يرد عليه ابن سينا وأجّل الإجابة لوقت لاحق.
وفي إحدى الليالي شديدة البرودة، طلب ابن سينا من تلميذه أن يناوله شربة ماء، لكنه تكاسل لشدة البرد. وبعد قليل بدأ المؤذن في التبتل ثم أذّن لصلاة الفجر. في اليوم التالي سأل ابن سينا تلميذه إن كان قد فهم لماذا لا يدّعي أستاذه النبوة، فأجاب التلميذ بلا. قال ابن سينا:
«إنه على الرغم من نفوذه في نفس تلميذه، إلا أن تلميذه تكاسل عن أن يناوله شربة ماء، ولكن نفوذ سيدنا محمد في قلوب أتباعه بعد وفاته بأربعمائة سنة جعل أحدهم يقوم من نومه في البرد القارس ليتبتل ويؤذن لصلاة الفجر»13.
ضرورة النبوة
لقد توصلنا إلى أن بلوغ الإنسان لكماله يستلزم بعث النبوات، وأوضحنا البرهان على ذلك. ولكن حين نقول إن النبوة ضرورية عقلًا، فهل هذا يلزم الله عز وجل أن يبعث أنبياء؟ هل نحن بذلك نقول إنه من الضروري على الله أن يفعل ذلك؟
إن المقصود بضرورة النبوة عند الحكماء أنه بمقتضى كمال الله وحكمته وصفاته العُلى أن يوصل كل الموجودات بما فيها الإنسان إلى كمالها. كقولي: زيد فاضل، إذن يجب أن يكون عفيفًا. هل أنا بهذا أجبرته وألزمته أن يكون عفيفًا؟ كلا، بل لأنه فاضل توجب أن يكون عفيفًا.
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية «أن ما وقع من أفعال الرب لابد أن يقع طبقًا لاقتضاء صفاته»، ويقول:
«لكن المقصود أن نبيّن أن ما وقع منه فهو واجب الوقوع في حكمته، لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك، فهذا استدلال ببيان أنه يجب أن يقع منه ما يقع، ويمتنع أن يقع منه ضده، وذلك ببيان أنه حكيم»14.
لماذا تقتضي الحكمة الإلهية إيصال كل مخلوق لكماله؟
يقول المحقق السبزواري في منظومته الشهيرة:
«إذ مقتضى الحكمة والعناية
إيصال كل مخلوق لغاية»15
ويقول السيد الداماد:
«وإذ كان الجود الإلهي مقتضيًا لتكميل المادة بابتداع الصور غير المتناهية فيها، وإخراج ما فيها بالقوة من قبول تلك الصور من القوة إلى الفعل... واحدًا بعد واحد»16.
لنَفهم كلام الحكيمين، تخيل معي ـ أخي القارئ ـ أن هناك بنّاءً كلي العلم وكلي القدرة، ومعه موارد لا تنفد، وقرر بناء بناية شاهقة. بعدما عرفت صفاته، هل تظن أنه من الممكن أن لا يتم البناء؟ أظن الإجابة واضحة.
الكون هو تلك البناية الشاهقة، وكل دور في هذه البناية بمثابة موجودات جديدة تدلف إلى مسرح الوجود. ذكرنا في بداية المقال أن الموجودات التي تكون موجودة بالقوة تظهر على مسرح الوجود بعدما تخرج من القوة إلى الفعل. إذن، إتمام بناء الكون يكون بإخراج الأشياء من القوة إلى الفعل لتصل إلى صورتها الأتم والأكمل. فإذا كان هناك موجود بالقوة ولم يخرج إلى الفعل، فهذا ـ حاشا لله ـ تقصير في إتمام بناء الكون.
يقول الداماد نقلًا عن الشيخ الرئيس ابن سينا:
«الأول تعالى (يقصد الله) تام القدرة والحكمة والعلم، كامل في جميع أفعاله، لا يدخل أفعاله خلل البتة، ولا يلحقه عجز ولا قصور. ولو توهّم متوهّم أن العالم يدخله خلل أو يتعقب ائتلافه ونظامه انتقاص، لوجب من ذلك أن يكون غير تام القدرة والحكمة والعلم، تعالى عن ذلك؛ إذ قدرته سبب العالم وسبب بقائه ونظامه»17.
نستنتج من هذا أن الجود الإلهي يقتضي إيصال المخلوقات إلى كمالها، والإنسان أحد هذه المخلوقات، ولهذا فبمقتضى العناية الربانية يجب أن يصل بعض أفراده إلى كمالهم الأخير، وهؤلاء هم الأنبياء صلوات الله عليهم.
رأي الإمام الرازي
يرى الإمام فخر الدين الرازي أن برهان الحكماء على النبوة العامة يتلخص في قدرة الأنبياء على تكميل الناقصين18، أي إيصال بني البشر إلى كمالهم، ومداواة نقائصهم وأمراضهم القلبية والنفسانية. إن هذا بيّن كالشمس في كبد السماء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فلْتنظر كيف كان سيدنا عمر بن الخطاب في الجاهلية إذ كان شديدًا على المسلمين، قبل أن يُخرج النبي فضائله من القوة إلى الفعل، ليكون الفاروق رمز العدل والقسط. وماذا عن الإمام علي بن أبي طالب الذي تربى في كنف النبي، فقال عنه الواقدي إنه «كان من معجزات النبي كالعصا لموسى وإحياء الموتى لعيسى»19.
فالصلاة والسلام على مُخرج فضائل العباد من ظلمات القوة إلى نور الفعل.
برهان النبوة في القرآن الكريم
هل في القرآن الكريم ما يدل على برهان النبوة عند الحكماء؟ يرى الإمام الرازي أن سورة العصر تحمل هذا المعنى؛ فلقد أقسم المولى عز وجل بالعصر أن الإنسان في خُسران وحرمان، ثم استثنى من هذا قليلًا من الناس. لماذا؟ لأن تلقائية الإنسان تجعله يتبع قواه الشهوية والغضبية التي تعيقه عن تكميل نفسه.
والمستثنون من هذا هم الذين لديهم كمال القوة النظرية (إلا الذين آمنوا) وكمال القوة العملية (وعملوا الصالحات)، ويسعون في تكميل القوة النظرية والعملية للغير (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)20.
وفي الذكر الحكيم آيات تدل على امتناع العبث في خلق الله للإنسان، مثل قوله عز وجل في سورة المؤمنون: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا)، وقوله تعالى في سورة القيامة: (أيحسب الإنسان أن يُترك سدى).
بالإضافة إلى ذلك، يقول المولى عز وجل في سورة الأنعام: (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء). تبين هذه الآية أن من ينكر بعث الله للرسل لم يقدر الله حق قدره. لماذا؟ لأنه ـ على ضوء كلام الحكماء ـ لم يدرك أن حكمة الله عز وجل تستلزم إيصال كل موجود لكماله وغايته، وهو بهذا لم يستوعب حكمة الله بشكل كامل ولم يعرف الله حق معرفته.
من الممكن أن نختصر رأي الحكماء في سبب بعث الأنبياء وعدم الاكتفاء بالحكماء والفلاسفة في أن:
الحكمة بحرٌ مِلح أُجاج لا يستسيغه إلا العالم بشؤونه ودواخله، فهو القادر على استخلاص لآلئ معانيه، أما الدين فعذبٌ فرات سائغ شرابه، فهو هدىً لكل الناس.